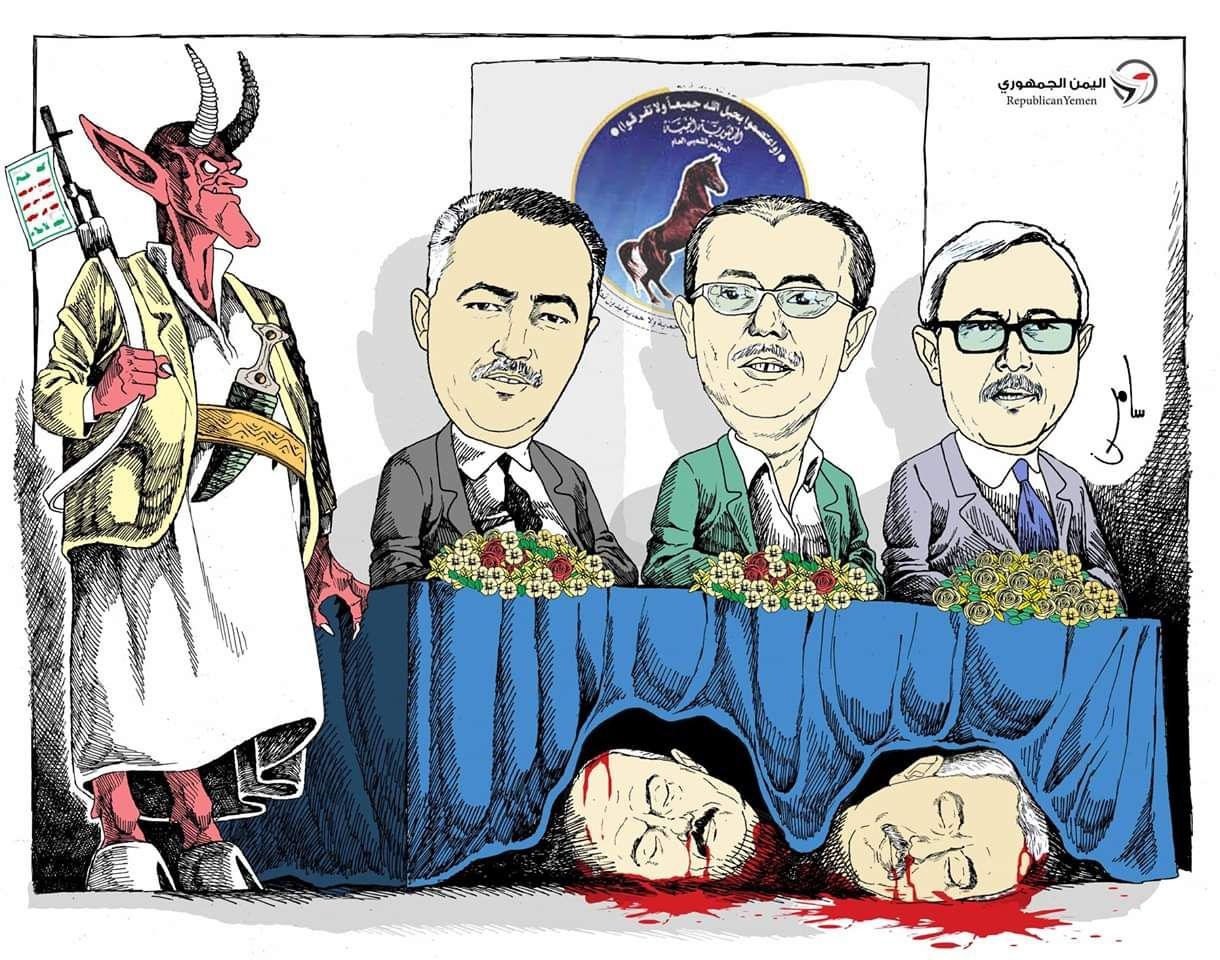قال الزعيم جمال عبدالناصر حينها بأنَّ «القاهرة هي صنعاء، وإذا سقطت صنعاء سقطت القاهرة»
الدور المصري.. دمٌ وتضحيات
الاحد 15 سبتمبر 2024 - الساعة 07:05 مساءً
المصدر : الرصيف برس - متابعات

بلال الطيب
لم تَكن ثَورة 23 يوليو 1952م المصرية حَدثًا عَابرًا مَحدود التأثير؛ بل كانت نقطة تحول فارقة في مَسار النضال الوطني الشَامل، جذبت إليها الأحرار العرب من المُحيط إلى الخليج، وأحيت إذاعتها إذاعة (صوت العرب) الروح القومية لديهم، وألهبت شعاراتها حماسهم، لتنتعش على وقعها ووقع خطابات الزعيم جمال عبدالناصر رغبات التحرر من الأنظمة الرجعية، والاحتلال الأجنبي، وهو ما كان.
حينما رأى الإمام أحمد ذلك المد الثوري الجارف يَتسلل إلى صُفوف الشباب اليمنيين المُؤمنين بالحرية والتغيير، حاول أنْ يتماهى معه، وأنْ يُقدم نفسه كَعُروبي أصيل، وشارك - تبعًا لذلك - الزعيم جمال عبدالناصر والملك سعود بن عبدالعزيز لحظات إشهار مِيلاد تَحالف عربي ثلاثي مُناوئ لحلف بغداد، من مدينة جدة السعودية 21 أبريل 1956م.
أراد الإمام أحمد بِمَوقفه ذاك أنْ يَضرب عُصفورين بحجر واحد، فقد أراد أولًا أنْ يخرس صوت القاضي الزبيري والأستاذ النعمان اللذان عاودا نشاطهما من القاهرة. وأراد ثانيًا أنْ يُثَبِت ولاية العهد لولده الأمير محمد البدر، على حساب أخيه الأمير الحسن، المُنافس القوي، وصَاحب الأنصار الكُثر، الذي سبق أنْ تخلص منه وعينه مَندوبًا في الأمم المتحدة.
أتقن الأمير محمد البدر الدور المرسوم له من قبل والده بعناية فائقة، قدم نفسه كشاب مُتحرر محب للتغيير، وتقرب من الأحرار الأوائل، والضباط الشباب، ومشايخ القبايل، وزار الاتحاد السوفيتي، وتشيكوسلوفاكيا، وألمانيا الشرقية، والصين، ووقع اتفاقيات تعاون وتبادل تجاري مع تلك الدول، وعمل - وهو الأهم - على شراء أسلحة حديثة، وهو أمرٌ كان له ما بعده.
أفكار قومية
كانت الأمراض المُزمنة قد أنهكت - حينها - جسد الإمام أحمد؛ وقد اتسمت سياسته تبعًا لذلك بالانتهازية والتردد، أجاد استغلال تلك التوترات، وظل خلال تلك الحقبة يلعب على الحبلين، وحين شُنَّ العدوان الثلاثي على مصر - مثلًا - أكتوبر 1956م؛ ظنَّ أنَّ نهاية الرئيس جمال عبدالناصر قد حانت، ونُقل عنه تشفيه بالأخير، ولم يتغير مَوقفه إلا بعد أنْ تدخل السوفيت لصالح الجانب المصري، وسارع بعد أقل من عامين، بطلب الوحدة مع مصر!
توالى في ذات الوقت وصول الأسلحة السوفيتية إلى ميناء الصليف، ووصل عددها حتى 4 أغسطس 1957م حوالي ثماني شحنات، وكانت تتكون من 30 دبابة من طراز (T.34)، و50 مدفع من طراز (RCA.100)، و100 مدفع ميدان، و100 مدفع مضاد للطائرات، و70 مُدرعة وعربة مصفحة، و20 طائرة، وكميات لا بأس من الأسلحة الخفيفة، والقنابل اليدوية، والذخائر.
وقد ظلت معظم تلك الأسلحة مُهملة حتى تَوالى وصول الخبراء الروس والمصريين. وفي الوقت الذي سارع فيه الاتحاد السوفيتي بإرسال فريق تدريب مُكون من 35 مُدربًا، و50 فنيًا، سارع جمال عبدالناصر بإرسال بعثة عسكرية مُكونة من 12 ضابطًا مايو 1957م، ثم عززها بعد مرور عامين ببعثة أخرى، وكانت مهمة هؤلاء جميعًا تدريب القوات المُسلحة اليمنية على الأسلحة الحديثة.
وذكر المقدم عبدالله قائد جزيلان أنَّ البعثة المصرية أتت بطلب من الأمير محمد البدر، وأنَّ الإمام أحمد لم يكن راضيًا عنها، وأضاف مُتحدثًا عن الأول: «كان البدر يبدو أمام الرأي العام رجلًا يدعو إلى الإصلاح، ولكنه كان في الحقيقة رجعيًا مُمعنًا في رجعيته»!
جاء بعد ذلك الحدث الأبرز المُتمثل بإعادة افتتاح الكلية الحربية في العاصمة صنعاء برئاسة العقيد حمود الجائفي، ثم المقدم عبدالله جزيلان، وهي الكلية التي كانت قد أغلقت بعد أحداث الثورة الدستورية فبراير 1948م. تلى ذلك إعادة افتتاح كلية الشرطة، وافتتاح مدرسة الأسلحة، ومدرسة ضباط الصف، وكلية الطيران، ومدرسة الإشارة، وهي التحولات التي مَهدت للقوات المسلحة اليمنية أنْ تخطوا خطوات جبارة نحو التطور التحديث، والأهم من ذلك تسلل الأفكار القومية التحررية إلى صفوف طلابها، الذين كان الضابط علي عبدالمغني أحدهم.
بدأت مع مطلع العام 1959م بعض المنشورات والمعلومات السرية تتسرب، وقد أشارت بمجملها إلى وجود حركة في صفوف العسكريين تسعى إلى قلب نظام الحكم، وقد أفاد أوبلانس - مصدر هذه المعلومة، وهو مُراسل حربي بريطاني - أنَّ السلطات الإمامية قامت بعد ذلك بإلقاء القبض على عدد من الضباط اليمنيين، وطرد الضباط المصريين.
وعلى خِلاف أوبلانس، ذكر عدد من المُؤرخين اليمنيين أنَّ الإمام أحمد قام بعد أنْ توترت علاقته مع جمال عبدالناصر باحتجاز الضباط المصريين في قصر الضيافة، وحَرَّم عليهم الاتصالات، ثم أرسلهم إلى القاهرة. وأفاد وجيه أبو ذكرى أنَّ هؤلاء الضباط المطرودين هم من كونوا فكرة صائبة عن اليمن لدى القيادة المصرية، وأنَّ الأخيرين استفادوا من معلوماتهم في التمهيد للثورة أيما استفادة.
قام الإمام أحمد بعد ذلك بكتابة أرجوزته الشهيرة، وهي الأرجوزة التي أذاعتها إذاعة صنعاء، وانتقد فيها توجهات ثورة يوليو الاقتصادية، وهو ما اعتبرته القاهرة تدخلاً سافرًا في شئونها الداخلية، وأعلن جمال عبدالناصر على إثرها وبشكل انفرادي عن إلغاء الوحدة بين مصر والمملكة المتوكلية 27 ديسمبر 1961م، وذلك بعد ثلاثة اشهر من انفصال سوريا عن ذلك الاتحاد الفيدرالي، والمفارقة الصادمة أنَّ الإمام أحمد هنأ الانفصاليين السوريين على تصرفهم ذاك!
ساعة الصفر
بعد مُحاولة اغتيال الإمام أحمد في مستشفى الحديدة، أغلقت السلطات الإمامية الكليات والمدارس العسكرية، وهو الأمر الذي حَفَّز عدد كبير من الضباط ذوي الرتب الصغيرة في الجيش والأمن على إيجاد تنظيم جامع يحتويهم، وبدأوا يفكرون بعمل مُنظم بدلًا من العمل الفردي غير المجدي، وعقدوا لأجل ذلك عدة اجتماعات تمهيدية، ثم أشهروا باجتماع تأسيسي مُوسع ميلاد ذلك التنظيم 10 ديسمبر 1961م، وقد تركز نشاطهم في المدن الثلاث الرئيسية (صنعاء، وتعز، والحديدة).
ومن ديسمبر 1961م وحتى سبتمبر 1962م تولى قيادة التنظيم أربع لجان، انتخبت الأولى فور التأسيس، وانتخبت الأخيرة قبل قيام الثورة بـ 22 يومًا، برئاسة الملازم علي عبدالمغني، والأخير لعب دورًا رئيسيًا وبارزًا في تأسيس ذلك التنظيم وقيادته، وهو من خريجي مدرسة الأيتام والكلية الحربية، وكان همزة الوصل وقناة الاتصال بين زملائه الضباط والقيادة المصرية، كما أنَّه وبشهادة كثيرين كان ذكيًا مُتقدًا، ووطنيًا مُتحمسًا، واسع الاطلاع، ممتلئًا بالشعور القومي، ذا قدرة جبارة في اجتذاب المُتعاونين.
اعتمد الضباط الأحرار على السرية التامة في تحركاتهم، وكان من الصعب أنْ يعرف أي عضو في أي خلية عن أعضاء الخلايا الأخرى، وحددوا في نُظمهم الداخلية إباحة دم كل من يفشى منهم سرًا، وأنْ يدفع كل عضو اشتراك شهري مقداره ريـال واحد.
ارتبط تنظيم الضباط الأحرار برموز وطنية في القطاع المدني، ونشطت تبعًا لذلك حركة التعبئة في أوساط فئات المجتمع، وفي تعز كان المُناضل عبدالغني مُطهر رجلهم الأمين في القيام بهذا الدور، وقال الأخير في مُذكراته أنَّ الملازم علي عبدالمغني زاره إلى منزله في تلك المدينة أبريل 1962م، وأخبره أنَّ التجمعات الوطنية - بما فيهم الضباط الأحرار - يُريدون حضوره إلى صنعاء للتفاهم معه حول سفره إلى القاهرة، خاصة وأنَّ السلطات المصرية طلبت منهم جميعًا إرسال شخص يكون محل ثقة للتشاور.
وبالفعل توجه المناضل عبدالغني مطهر إلى صنعاء، ومنها إلى عدن، ثم إلى القاهرة، والتقى هناك بأنوار السادات، ونقل له صورة شاملة عن الوضع في اليمن، وخلص مطهر إلى القول: «وقد انتهت لقاءاتنا مع المسئولين في القاهرة بقبولهم التعاون مع الحركة الثورية في اليمن خلال فترة الإعداد للثورة، وحمايتها بعد تفجيرها».
وأضاف: «وحين وصلت إلى تعز وجدت في استقبالي الأخ علي عبدالمغني الذي كان قد وصل إليها قبل وصولي بيومين، فسلمته تقريرًا شَاملًا بما أسفرت عنه رحلتي إلى القاهرة، كي يحمله إلى الإخوة الأحرار في صنعاء، وقد تضمن هذا التقرير فيما تضمنه من موضوعات وخطط ما تم الاتفاق عليه في القاهرة بشأن الأسلحة التي سوف تُرسل إلى صنعاء وتعز بالحقائب، وغيرها من الوسائل».
وفي صنعاء كان المناضل عبدالسلام صبرة هَمزة الوصل بين قيادة التنظيم والحركة الوطنية المدنية، والأخير تجمعه علاقة مُصاهرة مع الملازم صالح الأشول أحد أبرز قادة ذلك التنظيم، وفي منزله كان الاجتماع المُوسع الذي تم به تحديد ساعة الصفر.
في كتابه (التاريخ العسكري لليمن) استند المُؤرخ سلطان ناجي إلى روايات بعض الكتاب الأجانب، ورجح أنَّه قبل قيام الثورة كانت هناك أربع مجموعات مُختلفة تعمل على الإطاحة الفعلية بالعرش الإمامي، اثنتان منها تخصان قبيلتي حاشد وبكيل، والأخريتان تخصان الجيش وتنظيم الضباط الأحرار، وخلص إلى القول أنَّ الأخيرين هم من قاموا بالثورة فعلًا.
كان من المُقرر أنْ تكون تعز مُنطلقًا للثورة الشاملة، وفي 23 يوليو 1962م تحديدًا، إلا أنْ مَرض الإمام أحمد جعل الضباط الأحرار يؤجلون ذلك، وحين تحقق موت الإمام الطاغية 19 سبتمبر 1962م، لفظت تعز جثمانه، وشهدت صنعاء مقر ابنه الأمير محمد البدر إعلان قيام الجمهورية العربية اليمنية، وذلك بعد سبعة أيام فقط من تولي الأخير الحكم.
وهكذا، قامت ثورة 26 سبتمبر 1962م، الثورة التي جاءت لتفصل بين ماضٍ بكل أبعاده وتعثراته، وبين مُستقبل ينضح بالأمل، وتصدر الضباط الأحرار المدعومين من مصر العروبة، مصر الزعيم جمال عبدالناصر المشهد، وتحقق على يد هؤلاء الأبطال (البزغة) - كما كان يحلوا للإماميين أنْ يسمونهم - تحقق وعد القائد العراقي الرئيس الشهيد جمال جميل الذي قال قبل 14 عامًا من ذلك التاريخ في وجه قاتليه: «حَبّلناها وستلد».
وحين لم يجد الإمام المخلوع محمد البدر أرضًا يمنية يتمركز فيها، ولا قوة قبلية تُسانده، وأدرك أنَّ القوات الجمهورية مُستمرة في مُلاحقته، ولن تتركه يستعيد أنفاسه؛ سارع بالتوجه إلى الخوبة 24 أكتوبر 1962م، متجاوزًا الحدود اليمنية، واضعًا رهانه على الخارج، وهو الارتهان الذي دفع الثوار لطلب النجدة من الرئيس المصري جمال عبد الناصر، فأمدهم الأخير بسرية، ثم عززهم - كما سيأتي - بـ 70,000 مُقاتل.
وإلى جانب اعتراف مصر بالنظام الجمهوري، اعترفت سوريا، وقبلها الاتحاد السوفيتي، ثم تونس (سحبت اعترافها فيما بعد)، والجزائر، والعراق، والسودان، ولبنان، ولم ينته ذلك العام إلا باعتراف أكثر من 30 دولة، كانت الولايات المتحدة الأمريكية إحداها.
نبيل الوقاد
مُنذ اللحظة الأولى لقيام الثورة السبتمبرية، وقَعَ الجُمهوريون في شِراك التقديرات الخاطئة لحجم وقوة الثورة المُضادة، ولم يَستعدوا لـمُواجهة الإماميين وداعميهم الاستعداد الأمثل، والأشمل، وكانوا - رغم ذلك - مُؤمنين بقدراتهم، واثقين بأنفسهم، حَازمين في ردودهم، وكما كان انتصارهم خلال الليلة الأولى للثورة أشبه بالمعجزة، كان صُمودهم في وجه تلك الهجمة الشرسة أشبه بالمعجزة أيضًا، وهو الصُمود الذي أصاب أعداء الثورة والجمهورية والحياة في مَقْتل.
كانت لحظة استشهاد الملازم علي عبدالمغني انتكاسة كُبرى في مسار الجمهورية الوليدة 8 أكتوبر 1962م؛ لما يمثله ذلك القائد الفذ من رمزية فريدة، وللثأر له، ولصد الهجوم الإمامي، أرسلت القيادة - بعد مرور ستة أيام من استشهاده - بمجموعة من كتيبة الصاعقة المصرية تحت قيادة المقدم أحمد عبدالله، مسنودة بقواتٍ جمهورية، ومُنيت هي الأخرى وعلى مشارف مأرب بهزيمة قاسية، ودخلت بعد انسحابها إلى صرواح تحت دائرة الحصار الإمامي؛ الأمر الذي جعل القيادة تُرسل بحملة ثالثة 23 أكتوبر 1962م.
سَبق تلك الحادثة انضمام الشيخ ناجي بن علي الغادر والشيخ أحمد بن علي الزايدي للصف الجمهوري، وقامت القيادة فور وصولهما صنعاء بإعطائهما أموالًا وأسلحة، وكلفتهما ورعاياهما من أبناء خولان بالانضمام للحملة الثالثة، وهي الحملة التي تم تعزيزها ببعض الضباط، و150 فردًا من جنود الصاعقة المصرية بقيادة نبيل الوقاد، وأربع دبابات.
واجهت تلك الحملة انتكاستين مُتتاليتين، الأولى في القرب من باب الضيقة، حيث تعرضت لكمين إمامي غادر، قُتل فيه القائد الوقاد، والثانية بعد انسحابها إلى قلعة صرواح، حيث افتعل الشيخان الغادر والزايدي خلافًا مدفوع الثمن، انتهى بتصويب الأخير بندقيته على موظف اللاسلكي، وقيام أحد الضباط المصريين بالثأر لصاحبه، وتعاظمت تلك الانتكاسة بحدوث مُناوشات محدودة أدت إلى قتل وجرح عدد كبير من الجانبين، وتعاظمت أكثر بنجاة الشيخ الغادر، وخروجه إلى قبيلته مُحرضًا ومُعلنًا الحرب على الجمهورية والمصريين الذين وصفهم بالمُحتلين.
وكان قد وصل عدد القوات المصرية خلال ذات الشهر إلى نحو 2,500 جندي، و100 ضابط وصف ضابط، في حين تولى الفريق أنور القاضي قيادتهم، وكان لهم وأقرانهم الذين توالى وصولهم دورٌ فاعل في صد الهجمة الشرسة التي تعرضت لها الجمهورية الوليدة.
وهكذا، وإلى جانب قبائل مأرب، انضمت قبائل صرواح، وعدد كبير من أبناء خولان للجانب الإمامي، وقاموا مُجتمعين بالهجوم على القوات الجمهورية والمصرية (القوات المُشتركة) المتمركزة في قلعة صرواح، وأحكموا حِصارها، وذلك بعد أنْ خاضوا مَعها مَعركة شرسة استشهد فيها الملازم عبدالكريم الرازقي.
صحيح أنَّ القيادة في صنعاء حَاولت إنقاذ الموقف، وذلك بإرسال مجموعة من المظليين المصريين، إلا أنَّ الأخيرين هبطوا في المكان الخطاء (منطقة الوتدة)، وكان مصير مُعظمهم القتل على يد أبناء قبيلة جهم البكيلية، في حين ظلت المجموعة المُحاصرة قرابة الأربعة أشهر تتلقى الإمدادات جوًا، بالتزامن مع حدوث مُحاولات فاشلة لفك الحصار عنها.
أحمد شكري
وبالقرب من المناطق التي هَرب إليها الإمام المخلوع محمد البدر، تجمع حوالي 3,000 مُقاتل إمامي بقيادة عبدالله بن الحسين بن الهادي في وادي حرض، استعدادًا للانقضاض على المدينة المجاورة (مدينة حرض)، وقد استبقوا ذلك التجمع بالسيطرة على مدخل الوادي (قفل حرض)، وأسر سريتين جُمهوريتين كانتا مُرابطتين هناك، في حين نجا من الأسر طاقم الدبابة الوحيدة الذي انسحب بها بسرعة إلى داخل المدينة.
وتعزيزًا للقوات الجمهورية المُرابطة هناك، تم إرسال كتيبة مَصرية بقيادة اللواء أحمد شكري، وما أنْ توغلت تلك القوات مُجتمعةً في أحراش وادي حرض 2 نوفمبر 1962م، حتى تَعرضت لهجوم إمامي قُتل فيه القائد المصري وعامل اللاسلكي برصاصة واحدة، بالإضافة إلى 30 جنديًا مصريًا، وعددًا محدودًا من القوات الجمهورية.
استفاد الإماميون من أشجار وادي حرض الكثيفة؛ وكانت ضرباتهم تبعًا لذلك مُركزة، ولو كان اللواء شكري استمع لنصائح إخوانه الجمهوريين، ما حدثت - خلال نصف ساعة - تلك الانتكاسة. كان الشيخ مُجاهد أبو شوارب أحد أولئك الناصحين، وقال في شهادته - على تلك الحادثة - أنَّ القائد المصري سأله قبل بدء الهجوم: «هل لدى الملكيين دبابات ومدافع وألغام؟»، وحين أجاب بالنفي؛ قال له: «يا رجل لا تتردد، ولا تكن جبانًا، هؤلاء صراصير أنا أدوسهم بجنازير الدبابات»! وحصل في النهاية ما حذر منه الشيخ مجاهد وأصحابه، الذين شَاركوا في ذلك الهجوم الارتجالي مُضطرين، وكانت خسارتهم حين حصر الضحايا محدودة؛ لأنَّهم أخبر بالأرض، وأدرى بسلوكيات الطرف الآخر.
لم يهنأ الإماميون بانتصارهم ذاك طويلًا، دَفعتهم نشوته الخادعة لـمُلاحقة القوات المُنسحبة، وما أنْ اقتربوا منها، وفي ساحة مَفتوحة هذه المرة (أرض المطار)، حتى فتحت تلك القوات عليها النار، ومن جميع أنواع الأسلحة، وقتلت منهم المئات (قدرتهم إحدى الإحصائيات ما بين 300 و400 قتيل)، وجرحت عَددًا منهم، ومن نجا منهم لاذ بالفِرار، في حين أكملت القوات المُشتركة انسحابها إلى داخل المدينة، ومن الأخيرة - وفي ذات اليوم - أكملت القوات المصرية انسحابها إلى مدينة عبس المُجاورة.
وفي الجانب الآخر، وعلى مَقربة من حرض، عقد الإمام المخلوع محمد البدر مُؤتمرًا صحفيًا 10 نوفمبر 1962م، ظهر فيه أكثر تماسكًا وقوة، وأكد فيه عَزمه على استعادة عرشه، وعاد ومعه الكثير من الدعم إلى جبال اليمن الغربية، وأشرف بنفسه على قيادة ذلك المحور، وأظهر جلدًا غير مُتوقعًا، وبدأ من على سفوح جبل رازح - ومن مَنطقة حزة تحديدًا - في تجميع قواته، واستقطاب مشايخ المناطق المجاورة.
وفي نفس اليوم الذي عقد فيه الإمام المخلوع مُؤتمره الصحفي، تم التوقيع في القاهرة على مُعاهدة دفاع وتعاون مُتبادل بين اليمن ومصر، وتم تشكيل مَجلس أعلى مُشترك برئاسة العميد عبدالله السلال رئيس الجمهورية، وأنور السادات، الأخير مُمثلاً للرئيس جمال عبدالناصر.
وكان قبل ذلك التوقيع بأكثر من عشرة أيام قد قام المشير عبدالحكيم عامر بزيارته الأولى لليمن، وتضاعف عدد القوات المصرية بعد زيارته تلك إلى حوالي 8,000 جندي، بمعداتهم، وبدأ الإعلام المصري يتحدث عن سحق جيوب المقاومة الإمامية، والسيطرة التامة على حدود اليمن الشرقية والشمالية.
انتقل الإمام المخلوع بعد ذلك إلى منطقة غارب هيثم، القريبة من مدينتي حرض والمحابشة، وتركز كل همه حينها في السيطرة على تلك المنطقتين الاستراتيجيتين، وبالتزامن مع استمرار مُحاولاته الفاشلة في السيطرة على الأولى، كانت له أيضًا مُحاولات فاشلة للسيطرة على الأخيرة، وقد مهدت قواته لذلك بقطع الطريق عنها، من الجهة الشمالية الغربية؛ الأمر الذي جعل القيادة تُرسل من عبس بحملة من القوات المُشتركة، مَسنودة بالدبابات، والرشاشات، والمدرعات.
وفي الوقت الذي تمركزت فيه كتيبة من القوات المصرية في ربوع المحرق، تقدمت القوات الجمهورية بشقيها: العسكري بقيادة الملازم أحمد المتوكل، والقبلي بقيادة الشيخ علي قملان شمالًا إلى سوق عاهم، المطل على منطقتي وشحة وقارة، والقريب من مقر الإمام المخلوع محمد البدر، وقد شارك في تلك الحملة حوالي 60 فَردًا من أبناء يافع، المنضوين في صفوف الحرس الوطني.
حققت القوات الجمهورية بادئ الأمر انتصارات لافتة، وكبدت الإماميين في المحرق والضاحية ووادي الخميسين وسوق عاهم خسائر فادحة، إلا أنّ عدم كسب تلك القوات لسكان تلك المناطق، جعلت الإمام المخلوع يُلقى خِطابًا دعائيًا، في حين تَداعى أبناء قبائل حجور وأسلم والشرف للنكف، وقاموا تحت إشرافه بهجومٍ مُضاد، أجبروا فيه - بعد مَعارك ضارية - القوات الجمهورية على الانسحاب، وكبدوها - أيضًا - خسائر فادحة.
واصل الإماميون المزهوون بالنصر تقدمهم إلى ربوع المحرق، وقد استخدمت القوات المصرية مَعهم نفس الأسلوب الذي استخدمته مع أقرنهم في حرض، تَركتهم يتقدمون أكثر، ثم صوبت حمم نيرانها عليهم، وبشكل مُكثف، وأجبرت أرواح مُعظمهم على المُغادرة، ولم ينجو من ذلك الموت المحقق سوى قلة قليلة كانوا بعيدين عن مكان المُواجهة.
حملة رمضان
كانت تحركات الأمم المتحدة قد اقتربت حينها أكثر من القضية اليمنية، وبدأت تعمل على تطويق الصراع، وفض الاشتباك، وإحلال السلام، وأقرت لأجل ذلك إرسال هيئة مُراقبين دوليين إلى المنطقة المُلتهبة، واستباقًا لتلك الخطوة المدعومة أصلًا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية؛ توجه المشير عبدالحكيم عامر إلى اليمن 30 يناير 1963م (5 رمضان 1382هـ)، ولم تكن زيارته (الثالثة) هذه كسابقاتها؛ فقد جاء برؤية جديدة، وبِخطة شاملة تَهدف إلى إحكام السيطرة على جَميع الأراضي اليمنية، وتأمين طرقها الرئيسية، وإقفال حدودها.
ولأجل تنفيذ تلك الخطة؛ ضَاعف المصريون من أعداد قواتهم في اليمن، وقد وصل عددها إجمالًا إلى حوالي 20,000 جندي، وقيل أكثر، وقاموا - بالتنسيق مع القيادة الجمهورية، وفي بداية الأسبوع الثاني لوصول المشير عامر، وتحت قيادة الأخير - بهجومهم الكبير (هجوم رمضان)، مَسنودين بـ 200 طائرة وصلت للتو، وقد كان لسلاح الجو بشكل عام، وللدبابات والمدافع والمدرعات التي رافقت تلك الحملة، دورٌ فاعل في حسم المعركة خلال أقل من شهر.
توجهت القوات المُشتركة بادئ الأمر شَمالًا، وتَعرضت قبل أنْ تستعيد مُعظم مَناطق لواء صعدة لمُحاولة صد إمامية فاشلة، قادها الأمير محمد بن الحسين، الذي سارع فور علمه بذلك الهجوم، بتجميع 1,500 مُقاتل من مُعسكراته في نجران، إلا أنَّ القوات المُهاجمة فَرَّقت جمعه، ثم توجهت شرقًا، وبدأ بعد استعادة تلك القوات لمدينة المطمة، ثم الحزم، انهيار القوات الإمامية في المناطق المجاورة؛ وتمت - تبعًا لذلك، وبدون قتال - استعادة مدينة مأرب، ثم الجوبة، ثم حريب 7 مارس 1963م.
بالتزامن مع ذلك الهجوم، قام الجمهوريون عبر بعض الوجهاء - أمثال المناضل عبدالسلام صبرة - باستقطاب بعض قبائل طوق صنعاء، في حين قامت قوات تابعة لهم بتصفية بعض جيوب المقاومة الإمامية في ذات الإطار، وفي الوقت الذي تمركزت فيه بعض المجاميع القبلية الجمهورية في منطقة الخانق، وقطعت طَريق إمداد الإماميين في خولان الطيال، تمكن الشيخ سنان أبو لحوم ومجاميع من قبيلته من استعادة السيطرة على وادي السر في بني حشيش، واختراق قطاع نهم، ولم يمضِ من الوقت الكثير حتى استدعاه المشير عامر، وكلفه بالتوسط لدى قبيلة جهم من أجل فك الحصار عن كتيبة الصاعقة المصرية في صرواح، وقد نجح في ذلك، وجمهرت تلك القبيلة مُؤقتًا.
حقق هجوم رمضان بالمعيار العسكري نجاحًا كبيرًا، فهو لم يُجبر الإماميين على الانسحاب إلى الشعاب والكهوف البعيدة فحسب؛ بل حرمهم من منفذين هامين كانا يمدانهم بالأموال والأسلحة، وهما منفذا نجران وبيحان، ولم يتبق لهم إلا منفذ جيزان الذي استعصى على القوات المُشتركة، والمُرتبط بجبال رازح، وخولان الشام، وبني الحداد، والممتد عبر سلسلة جبال اليمن الغربية إلى مشارف مدينة حجة، وصولاً إلى بلاد آنس جنوبًا.
دواء لجروح النكسة
وتتوالى الأحداث، ويقوم المُعارضون للرئيس عبدالله السلال بحركة 5 نوفمبر 1967م، واعتبر البعض أنَّها - أي تلك الحركة - جاءت تنفيذًا لقرارات وتوصيات مُؤتمر الخرطوم (أغسطس من ذات العام)، واجتمع لمُواجهة ذلك قَادة سياسيون وعسكريون، وبعض قادة التكتلات الحزبية.
سُرَّ الإماميون لتلك التباينات، وفَسروه بالانشقاق الخطير؛ وبالفعل أجادوا استغلاله، وبدأوا بتحركاتهم الانقضاضية، وقد ساعدهم في ذلك التماهي انسحاب القوات المصرية، ومعها كل أسلحتها ومُعداتها، ثم مُغادرة الخبراء السوفيت على مرحلتين، وضعف الجيش الجمهوري، وعدم إمداده بالسلاح والذخائر.
كان أصدقاء النظام الجمهوري وأعداؤه - كما أفاد حسن مكي - على السواء، يرون أنَّ قدرته على الصمود والبقاء تقترب من درجة الصفر، وتأكيدًا لذلك قال الملازم أول طيار فارس سالم الشريفي أحد المُكلفين باستلام مطار الحديدة من القوات المصرية قبل مغادرتها اليمن، أنَّ مدير العمليات المصري خاطبهم يومها قائلًا: «لقد اشتركنا مع القيادة اليمنية في وضع الخطة الدفاعية عن صنعاء، ورغم ذلك نقول لكم: إنَّ تقديراتنا للموقف أنَّ صنعاء سوف تسقط، إلا أنْ تحل مُعجزة».
محسن العيني - رئيس الوزراء حينها - هو الآخر قال في إحدى شهاداته أنَّ جمال عبد الناصر قال له: «لا تشددوا، فنحن في ظروف عصيبة، وكل شيء يتوقف على شعبكم وقواتكم المسلحة».
كما أورد القاضي محمد إسماعيل الحجي أنَّ عبد الناصر التقاهم في القاهرة، ونصحهم بمصالحة الإماميين، وحين رآهم أكثر حماسًا، قال ناصحًا: «احمدوا الله على سلامة رؤوسكم، ماذا تعملون وأنتم بعدد الأصابع، بينما الجيش المصري بكل عدته وعدده لم يحقق الغرض المنشود».
وقبل أن أختم هذه التناولة، وجب التذكير أنَّ موقف الزعيم جمال عبدالناصر تغير تمامًا بعد ذلك، وبالأخص بعد سماعه بأخبار استبسال المُقاومين الجمهوريين في الدفاع عن عاصمتهم، وجه حينها بإرسال أكثر من خمسة ملايين طلقة رصاص شرفا وجرمل بكراتين المانجو (ماركة قها تحديدًا)؛ وذلك حتى لا يُلام على نقضه اتفاقية الخرطوم، وقدمت حكومته قرضًا بـ 40 مليون جنيه.
وذكر حسن مكي أنَّه التقى عبدالناصر أثناء الحصار، وأنَّه وجد قلبه وشعوره أكبر من أي مُساعدة؛ فقد أعطاهم روحًا معنوية بفرحته وسعادته لسماع أنَّ صنعاء لن تسقط، وخاطبهم قائلًا: «القاهرة هي صنعاء، وإذا سقطت صنعاء سقطت القاهرة».
من جهته أشار سنان أبو لحوم في مُذكراته أَّنَّهم توجهوا أواخر فبراير من العام 1968م إلى القاهرة، وذلك بوفد رسمي رأسه رئيس الوزراء الفريق حسن العمري، وأنَّ المصريين استقبلوهم بحفاوة بالغة لم يلقوها من قبل، وحين التقاهم عبدالناصر أبدى أسفه لما حدث من قبل، وخاطبهم قائلًا: «أنا خُدعت، وأسأنا إلى الشرفاء والثوريين ممن لهم التأثير في حياة اليمن، وأبارك لكم الانتصار، فانتصاركم هو انتصار لنا ولتضحيات مصر التي لم تذهب هبا، وهو رد اعتبار لي، ودواء لجروحي بعد النكسة..».