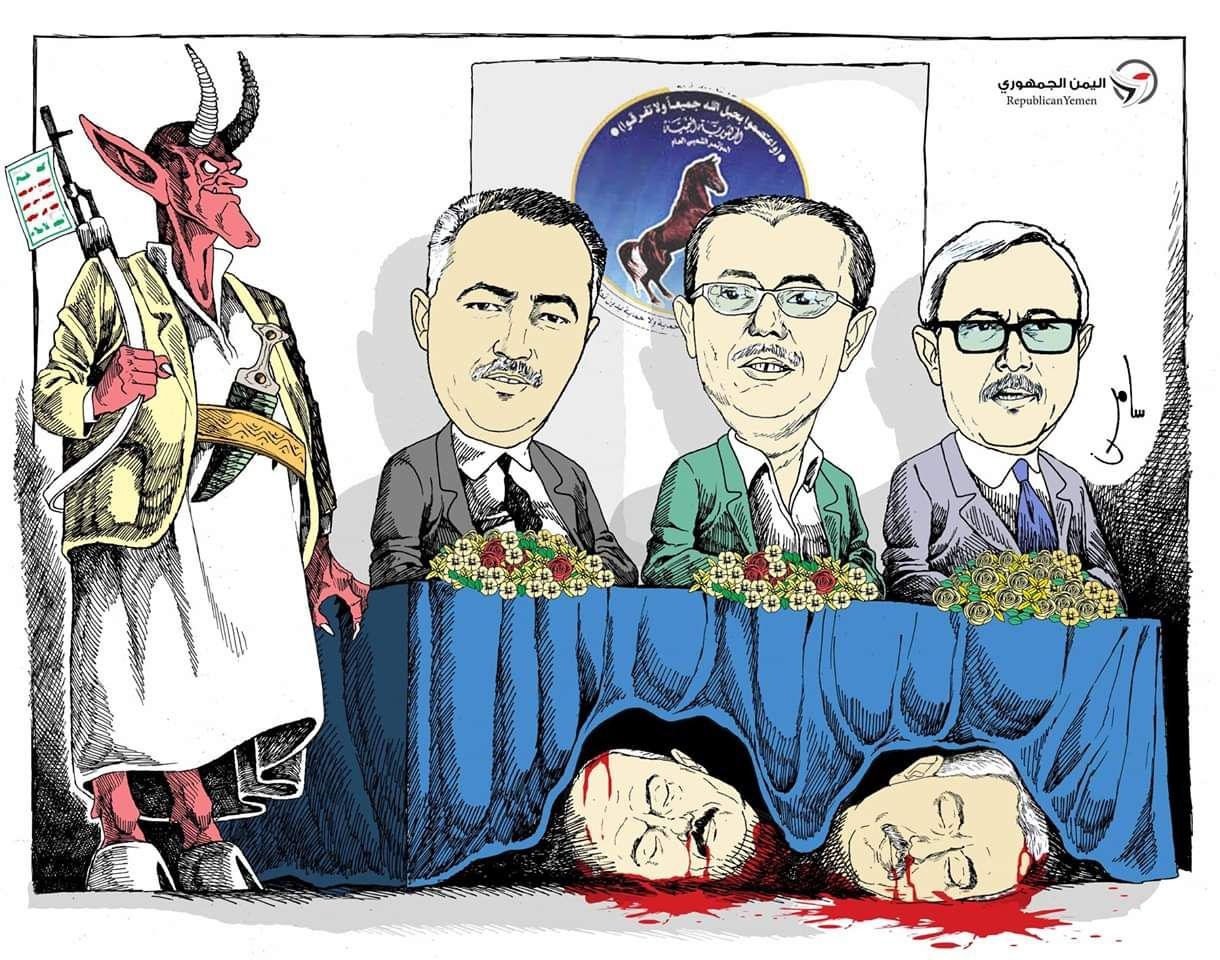للإنصاف وليس للدفاع عن أحد
الاربعاء 02 ابريل 2025 - الساعة 08:04 مساءً
قرأت أكثر من انتقاد لأحد الممثلين كونه عندما تم سؤاله عن رسالة الفن لم يدرك معنى مصطلح رسالة، ودليلهم على ذلك أنه أجاب: أن الفن مصدر رزق يوفر له ولأولاده لقمة العيش.
سبق أن كتبت في صفحتي أن المسلسلات اليمنية منفصلة عن الواقع الذي نعيشه.
ومع ذلك أجد أن إجابة هذا الممثل تعكس واقعا يعيشه كثير من الفنانين، خاصة في بيئة تعاني من أزمات اقتصادية وسياسية مثل اليمن من الطبيعي أن يكون الفن مصدر رزق، فهو في النهاية مهنة تتطلب جهدا ووقتا كأي عمل آخر.
ولكن أن يتحول الفن إلى مجرد وسيلة للبقاء دون الالتفات إلى قيمته الإبداعية والرسالية قد يكون أمرا مثيرا للنقاش.
لذا يمكن النظر إلى تصريح الممثل من عدة زوايا:
١. واقعية الطرح: حديثه صريح ويعكس معاناة كثير من الفنانين الذين يجدون أنفسهم مضطرين لاختيار أدوار لأسباب اقتصادية أكثر من كونها خيارات إبداعية.
٢. الفن بين الرسالة والمهنة: يمكن أن يكون الفن وسيلة للرزق، لكنه أيضا أداة للتأثير والتغيير، فالكثير من الأعمال الفنية التي غيرت المجتمعات ولدت من رحم المعاناة.
٣. تحدي الظروف: رغم الظروف القاسية ربما يكون الحل في إيجاد مساحة تجمع بين الاثنين بدلا من الفصل بينهما.
هل هذا مبرر لكل محتوى؟ إذا كان الفن مجرد وسيلة للعيش، فهل يعني ذلك أن الفنان يقدم أي عمل بغض النظر عن جودته أو رسالته؟ هنا يظهر التحدي الأخلاقي والفني الذي يواجه الفنان.
كان يمكن لمقدم البرنامج سؤال هذا الممثل: إذا تحسنت الظروف، فهل سيظل الفن بالنسبة له مجرد وسيلة للعيش أم سيحمل رسالة أعمق؟
ومن خلال إجابته يمكننا أن نحكم عليه، هل هو فنان أم مجرد مسترزق؟
أما ما يتعلق باتهامه بأنه لا يفهم معنى مصطلح رسالة بسبب إجابته، فدعوني أورد لكم أمثلة من الواقع الأكاديمي في الجامعات الحكومية في ظل الوضع المعيشي الحالي:
- الأستاذ الجامعي بسبب راتبه الذي لا يكاد يفي بإيجار مسكنه يفضل أن يعمل في الجامعات الخاصة أضعاف عمله في جامعته الحكومية حتى يستطيع توفير أبسط متطلبات العيش.
- بعض أساتذة الجامعة أصبح ولاؤهم للجامعات الخاصة يفوق كثيرا ولاؤهم لجامعتهم الحكومية.
- الأستاذ الجامعي إذا توافرت له فرصة الهجرة للعمل خارج اليمن لا يتردد، وبذلك أفرغت الجامعات الحكومية من عدد ليس بقليل من كوادرها العلمية.
فهل يحق لنا اتهام هؤلاء بأنهم لا يفهمون معنى رسالة كونهم تخلوا عن رسالتهم في خدمة جامعاتهم أو قصروا فيها وفضلوا البحث عن مصدر أفضل للعيش الكريم؟
أعتقد ليس من الإنصاف اتهامهم بذلك، فالحاجة إلى الأمن المعيشي يقع في بداية سُلّم الحاجات قبل الحاجة إلى الحب والتقدير والانتماء والمعرفة وتحقيق الذات.
أرى أن الحلول لكل الأوضاع المأزومة تتطلب دولة وتوجه لمعالجتها، فهل ننتظر معجزة لتوليد هذه الدولة؟ أم علينا العمل على توليدها؟
Jodi
2025-May-21After checking out a few of the blog articles on your blog, I really like your technique of writing a blog. I bookmarked it to my bookmark site list and will be checking back soon. Please check out my web site too and let me know what you think. casino en ligne fiable Exceptional post however I was wanting to know if you could write a litte more on this subject? I'd be very grateful if you could elaborate a little bit further. Appreciate it! casino en ligne It's impressive that you are getting ideas from this post as well as from our argument made at this time. casino en ligne France Unquestionably believe that which you said. Your favorite reason appeared to be on the internet the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks casino en ligne francais This is a topic that is near to my heart... Take care! Where are your contact details though? casino en ligne It's wonderful that you are getting ideas from this article as well as from our discussion made here. casino en ligne fiable I blog quite often and I genuinely appreciate your information. This great article has truly peaked my interest. I am going to take a note of your website and keep checking for new information about once per week. I subscribed to your RSS feed as well. meilleur casino en ligne Thank you for the good writeup. It actually used to be a amusement account it. Look complicated to far brought agreeable from you! However, how could we communicate? meilleur casino en ligne I blog quite often and I truly appreciate your content. The article has truly peaked my interest. I am going to bookmark your website and keep checking for new information about once a week. I subscribed to your Feed as well. casino en ligne fiable It's very trouble-free to find out any topic on net as compared to textbooks, as I found this post at this web page. casino en ligne France