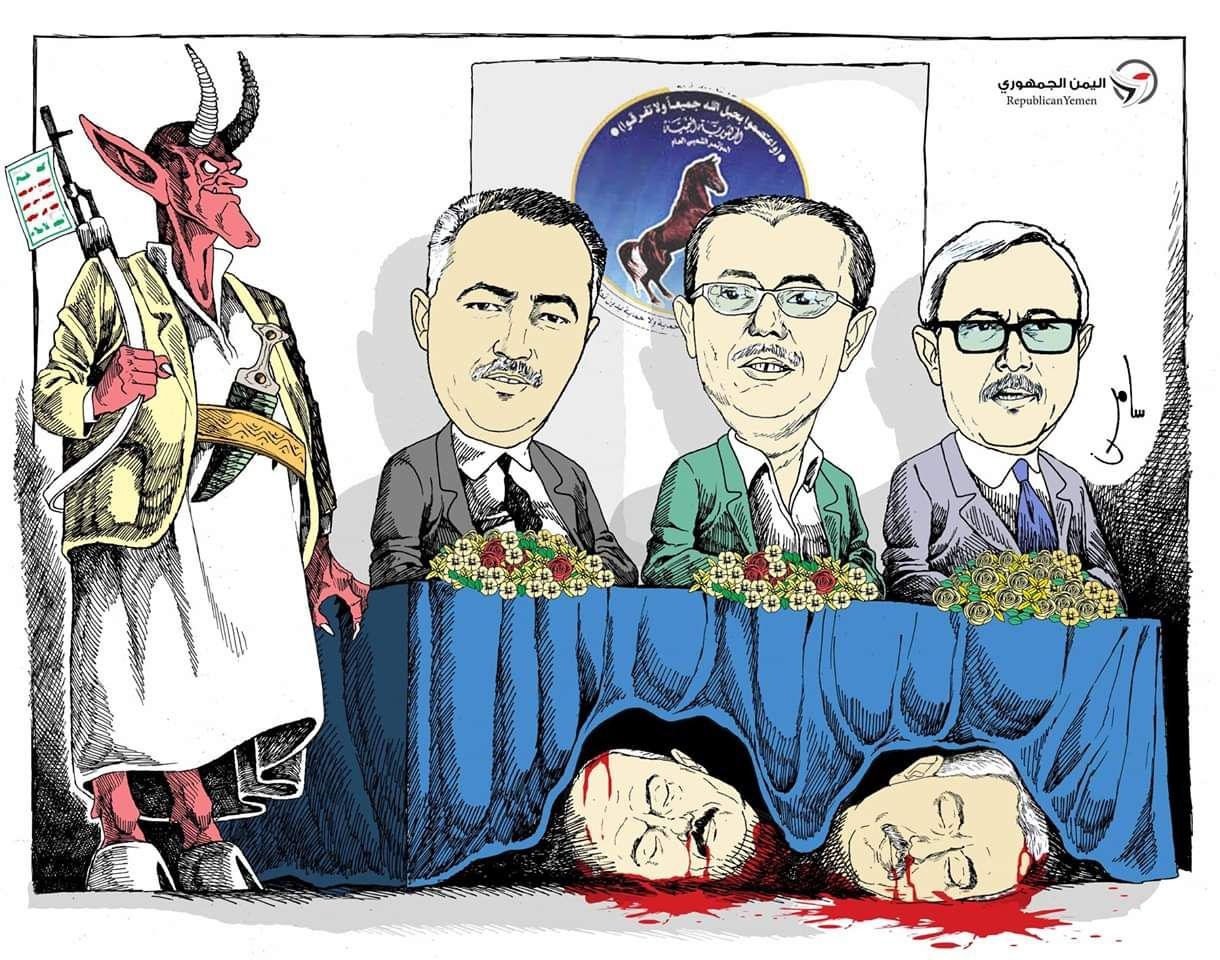الغربة بين يد تمتد للارتقاء وأخرى للتعثر
الاثنين 11 أغسطس 2025 - الساعة 08:00 مساءً
في رحلة الحياة، كثيرًا ما نغادر أوطاننا بحثًا عن حلم، أو هربًا من ألم، أو طلبًا لفرصة جديدة. لكنها ليست مجرد مسافة جغرافية نقطعها، بل هي حالة غامضة في القلب والعقل. الغربة ليست في المكان، بل في بُعد القلوب، وفي الشعور بالوحدة وسط جموع لا نعرفها، وفي السؤال الدائم: هل لي هنا مكان؟
هناك من يمد يده للغريب فيرسم له طريقًا للنجاح والارتقاء، وهناك من يمد قدمه ليجعله يتعثر في درب الغربة الطويل. هنا تبدأ المعركة الحقيقية، بين روح ترفض الانكسار وقلب يتوق للحياة والكرامة.
كانت ليلة شتوية باردة حين هبطت الطائرة في ملبورن، والسماء تمشط وجه المدينة بخيوط مطر رفيعة، بينما الريح تعصف بأوراق الشجر كأنها تطاردها إلى آخر الشارع. كنت أحمل حقيبتي على كتفي، وأحمل في قلبي دفئًا من نوع آخر؛ دفء اسمٍ عالق في ذاكرتي منذ أيام جامعة الملايا: مظفر النعمان.
كان مظفر يومها قد أخذني إلى جنتنج هايلاند، دفع كل التكاليف بابتسامة رجل كريم لا ينتظر مقابلًا، وكأنه يشتري لنا يومًا من الفرح وسط تعب الغربة. وها هو الآن، بعد سنوات، ينتظرني في المطار، يمد لي شريحة هاتف، ويقول:
"هذا رقمي… تواصل معي متى احتجت."
حمل عني الحقائب، أوصلني إلى الفندق، ثم عاد في المساء ليأخذني في جولة داخل المدينة. ومنذ ذلك اليوم صار ينتقل بي من فندق إلى آخر حتى استقريت في غرفة صغيرة استأجرتها من رجل باكستاني. وكان مظفر يتصل دومًا ليسأل:
"كيفك؟ تحتاج شيء؟"
وكنت أجيبه: "الحمد لله"، وأدرك أن بعض الكلمات أبسط من أن تُشترى، وأغلى من أن تُنسى.
لكن رمضان جاء… ورمضان، كما أعرفه، يكشف المعادن. فجأة، صارت تصلني همسات من هنا وهناك، لهجة يمنية ثقيلة تتساءل:
"كيف يعيش غزوان بلا عمل؟"
كأنهم يراقبون مؤشر الأكسجين في رئتي.
وذات مساء، جاءني أحدهم يسأل:
"ليش ما تشتغل؟"
قلت بهدوء: "ما أريد الآن."
فانفجرت من فمه عبارة قذرة لم أتخيل أن تصدر من رجل في الغربة:
"هل في طيزك دود؟"
ابتلعت الكلمات، وتمسكت بحكمة قديمة: "الصمت عن الأحمق شرف".
مرت أيام، ودعاني زميل قديم من أيام البكالوريوس للعشاء. تخيلت اللحوم والشوربة والابتسامات، فإذا بالمائدة مفروشة بأطباق الغيبة. كانوا يمضغون الكلام عن فلان وعلان، وأنا أضع اللقمة في فمي وأقول:
"فلان هذا رجل عملاق."
ارتبك المجلس، وشربت الماء وكأني أطفئ جمرًا في حلقي.
ثم ذهبت يوما الى ديوان الشيوخ في تارنت. بدأ الحاضرون يغتابون شخصًا أحترمه، ثم التفتوا نحوي وكأنهم ينصبون فخًا:
"ما رأيك في مظفر؟"
ابتسمت وقلت: "مظفر رجل عملاق."
فتسربت الضحكات الخافتة:
"عملاق ها… عملاق ها…"
لكن المشهد الذي لن يمحى من ذاكرتي، كان حين ركبنا السيارة، وجاء اتصال لصديقي:
"هناك ذبيحة في الديوان."
التفت إليّ مبتسمًا: "حظك… عزومة!"
بعد دقائق، عاد صوته متغيرًا:
"الشباب مش موافقين يجي غزوان."
ثم همس لي:
"ادخل الغرفة الثانية… مش غرفة الضيوف."
هناك، اكتملت لوحة اللؤم أمامي.
وما صدمني أكثر، أن بعض هؤلاء حملوا معهم حقيبة أخرى غير حقائب السفر… حقيبة مليئة بأمراض المجتمع اليمني التي كنت أظن أن الغربة قد تشفيهم منها. جاؤوا ومعهم الغل، والحقد، والحسد، والغيبة، والنميمة، وكأنهم يخشون أن يبرد الشر في صدورهم إن تركوه خلفهم. هنا، في أستراليا، رأيت في عيون بعضهم نفس التعالي الفارغ الذي يميز ضعاف النفوس، ونفس عبادة المال التي تحوّل الإنسان إلى آلة تجمع دون أن تشبع، وتعدّ دون أن ترتوي. كان مشهدًا مقززًا للنفس، أن ترى قارات تبعدك آلاف الكيلومترات عن الوطن، لكنك تكتشف أن الوطن بكل أمراضه القبيحة قد لحق بك، متجسدًا في بعض الوجوه والضحكات الباردة.
بدأت أضيق بملبورن، لكن الله عوّضني بأناس كالبلسم في شمال المدينة وجنوبها؛ الدكتور أحمد الأغبري، الدكتور نائف السويدي، الدكتور زكرياء الشعاث، المهندس حميد رشيدة… وغيرهم من النبلاء الذين غسلت صحبتهم مرارة الأيام.
ومع ذلك، قيلت أمامي كلمات جارحة:
"شهادة الدكتوراه قرطاس."
"ما لها فائدة."
حينها فهمت أن بعض الناس، حين يرونك تحفر جدار الغربة بحثًا عن نافذة، يحاولون إقناعك أن الجدار قبر.
في أستراليا تعلمت أن الغربة ليست بعد المسافة، بل بعد القلوب. وأن البشر نوعان: من يمد لك يده لترتقي، ومن يمد قدمه لتتعثر. وفي النهاية، الطبع يغلب التطبع، والقرية قد تسافر إلى آخر الدنيا، لكنها تبقى قرية في عقول بعض أهلها.